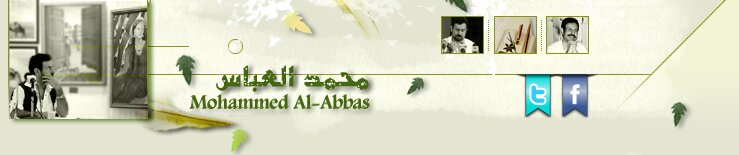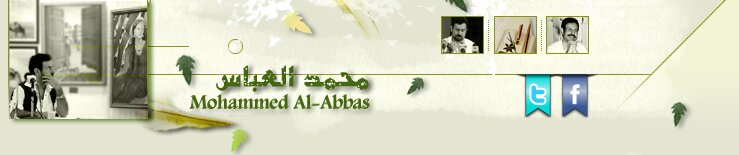طباعة طباعة  ايميل ايميل
من المربع الى العذيبات
الجدار خطاب اجتماعي .. والمرأة مجس لعالم البيت الغامض
العمارة فن وظيفي يجهد لتشكيل الفراغ والإقامة فيه ، وهو بهذا المعنى منتج انساني مادي وثيق الصلة بمسألة الهوية ، حيث يقوم في الأصل على فكرة لا مادية ( ثقافية ) يكون فيها الشكل الخارجي واحدا من مجموعة عناصر تقنية وبصرية واجتماعية وحضارية يمكن بموجبها الحكم على جمالية ووظيفية المنجز المعماري ، أو هذا هو البعد الحضاري الخلدوني في المسألة العمرانية الذي يرتكز عليه كتاب الدكتور مشاري النعيم ، الصادر عن سلسلة كتاب الرياض تحت عنوان " من المربع الى العذيبات – رؤى وافكار في العمارة السعودية المعاصرة " والذي يؤكد في كل مفاصله على أن الإنسان هو جوهر العمارة مهما تشاغلت بالملامس والخامات والألوان والتجويفات والمظاهر النحتية.
ويبدو أن النعيم أقرب الى منطلقات هولدن القائلة بأن الانسان يسكن شاعريا ، في اشارة الى ضرورة وجود مخيال للبيت والحي ، فالكتاب لا ينكفئ على فرضيات الخطاب المعماري ضمن اشتراطاته الذوقية وأنساقه المعرفية الداخلية وحسب ، بل يختبره على محك جملة من الخطابات الانسانية ليرفده من خارجه بدافعية ثقافية منفتحة ومغايرة ، فالمعماريون برأيه هم جزء من الواقع الثقافي لا خارجه ، وعلى ذلك الاعتقاد يحدث التماس ، وان بملامسة عابرة للعناويين ، مع جدلية الهوية كما تتمثل في تصورات ديفيد هيوم وهيرش وصداها العربي عند تركي الحمد ، ومحمد عابد الجابري ، كما يجادل ثقافة التشرذم والإنقطاع عند عبدالله الغذامي ، ويطاول بشيء من الاقتضاب نظريات التلقي عند ياوس ، ليؤكد على أن العمارة ليست خطابا منغلقا على الهندسة والكتل والخامات.
ولأن المشهد بالنسبة للنعيم كان بمثابة ورشة عمرانية هائلة ، يتشكل فيها المكان والانسان والانتصابات العمرانية جنبا الى جنب ، على ايقاع صاخب ومتسارع ، صار يقابل كل تلك الطروحات الثقافية باجتهادات طابور طويل من المعماريين المعنيين بالبنية التصويرية العالمية ومسائل الهوية والحيز الحضاري لمقاربة الآليات المولدة لسماتنا الثقافية العمرانية، حيث كان من الضروري استدعاء شالرز مور ، وسليد بيكر ، وفرانكو البيني ، وستانفورد اندرسون ، وربابورت ، وشالرز كوريا ، وروبرت فنتوري ، وبي في جينسن – كلينت ، وميس فان دوره ، وفرانك لويد رايت ، وأنتون ميزر ، الذين كان لبعضهم بصمة معمارية في التخطيط العمراني للمملكة ، للوقوف على وجهات النظر الحداثية الصادمة فيما ينبغي وما لا ينبغي محوه من خريطة القرية التي كانت تتعرض لعمليات تحديث شامل ، وفق تصور حداثي كاسح أراد أن يضبطه تركي السديري في مقاله " ما بعد جدار القرية " بتمكيثه الجدلي في منطقة اختلاف على " ما يجب أن نأخذ أو نترك ".
وكل تلك الاستشهادات المعرفية لا تنم عن الدراية بفن العمارة وحسب ، انما تؤكد رغبة النعيم الجادة في التقاطع مع الطروحات العمرانية العالمية بروح نقدية يراها حتمية لمجادلة منجزنا العمراني وطموحاته ، من خلال اعادة النظر في مصطلح النقد الذي لم يتطور برأيه في الوعي العربي " ليعكس القيمة التعليمية والتطويرية التي يحتويها هذا المصطلح " داعيا الى تخفيف الحساسية المفرطة تجاه كلمة النقد ومستخدميها ، فهو محتج على الحفظ المتحفي للتراث العمراني ، وغير مقتنع " بما يحدث داخل المدينة السعودية " بالنظر الى الغياب الكامل لمفهوم الحيز الحضري ، وعلى ذلك يطالب الجنادرية كمهرجان للثقافة والتراث بتفعيل حركة النقد المعماري لرسم ملامح فكرية عمرانية واضحة وهذا لا يمكن ، بتصوره ، دون وجود وعي جماهيري بأهمية العمارة كمنتج ثقافي متوارث ، كما يحمل المهرجان مسؤلية بناء العلاقة المتلازمة بين الثقافة والعمارة ، وهو ما يمثل دعوة صريحة للجمهور للاحساس بالعمارة والتورط في قضاياها.
على ذلك التصور النقدي يمكن اعتبار الكتاب محاولة جادة لفك الأقواس عن المعماري العربي الذي لا زال حسب تصوره " يعيش داخل مربع الثقافة الموروثة والسائدة " وهنا يكمن اعتراضه أيضا أو تحفظه على منجز المعماري حسن فتحي فسر شهرته يكمن في كونه مفكرا وناقدا لا معماريا قادرا على توفير الشرط المعماري/السكني للناس ، بالنظر الى الفراغ الموحش الذي يحتل مفاهيم العمارة العربية ، أما عمارته فلم يتجاوب معها الناس ، وعلى ذلك الاحتجاج ينادي بالتوجه لدراسة " بيئتنا العمرانية المعاصرة بعمق وفهم مشاكلها بدلا من النظرة النوستالوجية للبيئة التقليدية عن طريق المناداة بفضائلها التخطيطية والاجتماعية ومحاولة فرضها على بيئتنا المعاصرة ".
وإذ يستعين على هذه المهمة بآراء متخصصين لقراءة تداعيات " النسيج العمراني " كالناقد المعماري آرنهيم ، والمنظر المعماري كريستوفر الكسندر ، حتى في اشكاليات المهنة ومتطلباتها يستدعي طروحات الباحثة في ممارسة المهنة المعمارية دانا كاف، يستمد ملامساته العمرانية الفطنة بعينه المدربة على التقاط زوايا الرؤية العمرانية من مشهدية السينما ، وسردية الرواية ، وتهويمات التوصيف الشعري ، المعنية بالفضاءات المكانية ، وايضا من الدراسات النقدية الجمالية كما هي عند غاستون باشلار في جمالية المكان مثلا ، وفي الطروحات الأنثروبولوجية المعمقة عند ليفي شتراوس ، وذلك وفق المعيارية الخلدونية المتأتية في الأصل من النظر الى العمارة من خلال الثقافة والعكس ، والتي ترى أن العمران الثقافي أرقى أصناف التحضر.
اذا فهو كتاب طموح لا لأنه يجهد من الوجهة الثقافية/الحضارية الى تأكيد الهوية المعمارية وحسب ، بل لأنه من الناحية الجمالية/التقنية يسعى الى رفع منسوب الإحساس بالعمارة ، على اعتبار أنها ، أي العمارة " قرار يومي يتطلب تقنية يومية تحقق الحاجة الاجتماعية الفعلية " ، وهو مكتوب بشاعرية مؤانسة تذكرنا بأسلوب ستين راسموسين من حيث الإتكاء على بساطة الطرح ، وعمق المعرفة ، وكثافة الاستشهاد والاحالات والمقارنات الجمالية ، وكذلك الانطلاق من مرجعيات جمالية /هندسية واختبارها ضمن أطر فنية مرنة دون سجال تدليلي .
وبالنظر الى حساسية مسألة الهوية في الفكر العربي المعاصر لا يبدو مستغربا أن تحتل مساحة عريضة من جدلية الكتاب وان في صيغة تساؤلات عن السبب الذي يتعذر بمقتضاه أن تكون لنا فلسفتنا العربية –الاسلامية في عمارتنا المعاصرة ! فبرأيه هذا هو السؤال المحوري الذي ينبغي ان يجيب عليه معماريونا بدلا من ان يكرر بعضهم بعضا ، وبدلا من تصنيف الاعمال المعمارية طبقا لمصطلحات غربية تؤكد انهزامنا الثقافي " فأزمة الهوية ، باعتقاده ، لم تنشأ الا عندما تم تبني مناهج التعليم المعمارية الغربية ، مبديا في هذا الشان تحفظا تأمليا على هاجس الهوية العاطفية والتاريخية المحنطة فالماضي ليس بالضرورة نبعا للعفة والبراءة ، بل هنالك ما يشبه الصراع بين الثقافي والعمراني انطلاقا من مفهوم التراث والمعاصرة والهوية والاصالة ، الأمر الذي يتطلب انتباها استثنائيا للحظة التحول العمراني مع الرغبة في الحفاظ على منظومة القيم البصرية والفراغية والوجدانية.
أما مسألة الاحساس بالعمارة فلا تنفصل عن الهوية بأي شكل من الأشكال فهي تعتمد في المقام الأول على مفاعلة الثقافة بالمادة ، أي عدم الاكتفاء بالبصر الخارجي بل النفاذ الى التجويفات ، والتركيز على ان تكون عمارتنا المعاصرة عمارة قيم وليست عمارة شكل فقط ، فالجدار بتصوره ، ليس مجرد فاصل بين فراغين او بين وسطين بل هو تعبير عن خطاب اجتماعي ، وعلى ذلك يتجاوز عند قراءته لمدينة الرياض تمظهراتها السردية الى عمق صورتها الأنثروبولوجية ، ويتمنى أن يتخذ ساكنوا الرياض قرارات عمرانية الى جانب المسؤلين ، وألا يكون القرار دائما من الأعلى الى الأسفل ، بل بتفاعل القاعدة والقمة في المسألة العمرانية ، فالعمارة لا يمكن الاحساس بها بدون تجربتها ، أما الحي السكني فيراه تجربة اجتماعية ثقافية مخيالية وليس مجرد قضية تخطيطية او مشكلة تصميمية، الأمر الذي يستلزم اعادة قراءة قوانين البناء لدراسة تأثيرها على سلوكيات المجتمع ، ليحظى التصميم الحضري بالاهتمام الأكبر.
هكذا يربط النعيم الوعي العمراني بمتوالياته الثقافية الجمالية الاقتصادية ، بحثا بوسائل عمرانية عن حل اجتماعي، انطلاقا من التفكير في مفهوم المكان ، ومدى ارتباطه بمنظومة معقدة من الصور والبنى الزمانية والانسانية ، التي قد تحقق بشيء من المعرفة والملامسة الجمالية " عمارة تساهم في تميز المدينة ثقافيا " فالمسألة بالنسبة اليه تعليمية بالدرجة الاولى اذ تعاني برامج التعليم المعماري من اشكالية الفني – التقني ، وعلى ذلك يقترح ، تفعيل الثقافة المحلية في برامج التعليم العمراني ، وضرورة تكوين مجلس لتقييم برامج التعليم المعماري في المملكة ليس من اجل ضمان جودة التعليم المعماري بل من اجل ضمان كفاءة التعليم العالي بشكل عام.
ذلك الاكتناز المعرفي المؤسس على ولع صريح بالعمارة كتخصص ، وتلك الحساسية الجمالي المعاصرة هي التي تمكن النعيم من محايثة اشتراطات الحداثة كما هي مطروحة ومجادلة عمرانيا وثقافيا ، فالكتاب يعكس بأمانة شكل الجدل الحداثي ، وحدة طروحاتها المادية واللامادية المختلفة ، لكنه يبدو في أغلب المفاصل تطرفا حداثيا محببا بالنظر الى جهده الواضح في تشيئ الفكرة ، سواء على مستوى الحداثة الإنتقائية كما سجلها ابروكرومبي الذي زار المملكة سنة 1966 فكتب " اينما ذهبت وجدت السعوديين مرحبين بالقرن العشرين ولكن ليس بيدين مفتوحتين " أو في آفاق المقترح الفانتازي الذي ينادي به النعيم ممثلا في فن الكتابة على الجدران " الغرافيتي " واعتباره عملا ابداعيا ضروريا لمدننا ، أو ضمن الجدل المعرفي المعمق الذي يفرق فيه بوعي سوسيو-ثقافي بين معاني البيت والمسكن والعائلة ، ورهافة الخطوط الفاصلة بين مفاهيم غاية في الالتباس تتمثل في المحلية والتقليدية والاقليمية كمفاهيم لها حضور في الساحة الفكرية العمرانية .
ويبدو أن النعيم يتورط في نزعته الحداثية ويستأنس بدافعيتها كلما اقترب من الفكرة المؤسسة على الارتباط الانساني والمكاني الذي يمثله المسكن كحاضن زماني لاجيال متعددة ، وعلى الآلية المتوخاة في أهمية الشكل لامتصاص مقاومة المجتمعات للتغيير ، والآليات الدلالية المولدة للسمات الثقافية للمبنى الذي يعكس وحدة بصرية مستوعبة ضمن منظور العين البشرية ، وما يتبع ذلك من جدل تأصيلي حول " ثورة مواد البناء التي تشهدها اسواقنا حاليا " واستئثار الخرسانة " كمادة بلا هوية " بعناصر البناء واندحار خامة الطين أمام سطوتها ، ومسألة الاعتماد الكلي على الحاسوب الذي يهدد الحساسية المعمارية وينخرها في صميم جمالياتها ، كما يجادل خطر العولمة على السوق المهنية ، وجناية " المكاتب السيارة " وعليه يقترح السعي الى تنشئة أكاديمية مقنعة للمهندس المعماري ، وتوطين الخبرة الهندسية ، ودراسة " ثقافة الممارسة " واعادة النظر للمكتب الهندسي باعتباره نواة للثقافة المهنية، بل والتعاطي مع المهندس المعماري المؤهل كفنان وليس مجرد مهني ، والالتفات الجاد الى مسألة حقوق الملكية الفكرية للتصاميم المعمارية.
انه كتاب حداثي بامتياز يوظف كل الامكانات المنهجية والخطابات المعرفية للاقتراب بشكل حفري جاد من عالم الاسرة السري في مجتمعنا ، لتبيان حقيقة السلوك البيئي داخل مساكننا ، من خلال التركيز على الانسان في المسالة العمرانية ، بمعنى أنه يتجاوز الانتصابات العمرانية المادية أو يستخدمها للنفاذ الى المعنى الانساني المطمور تحت المباني ، وعلى ذلك يوظف المرأة كمجس لذلك العالم الغامض ، على اعتبار ان المسكن بالنسبة للمرأة يمثل مكانا ذا بعد زمني ، فقد باتت لأسباب ذوقية وتنموية وبالنظر لمحاذير اجتماعية كثيرة تتصدى للدور الأهم في تكوين مسكنها بصريا وفراغيا واجتماعيا ، وربما نتيجة لهذا التمادي صار مجلس الرجال يطرد الى خارج التكوين الفراغي للمسكن ، أو يعزل لصالح مجلس النساء ، الأمر الذي يؤدي الى تضاؤل اللقطة العاطفية في مساكننا ، وارتهانها لجمالية شكلانية باهضة ومكلفة .
هكذا يقارب النعيم الخطر الذي يهدد الفكرة المحورية التي يقوم عليها التنظيم الفراغي للمسكن العربي ، وهو اختلال فراغي فادح الخطر حتى على الشكل الخارجي المثقل برموزه البصرية التعويضية ، والمبالغة في الحفاوة ، التيتلغي ألفة البيت بتعبير بودلير،كما تتحطم على محكها مقولة مضللة اجتماعيا " البيت بيتكم " فرغم الحفاوة التي نبديها للضيوف الا اننا لا نطلعهم حقيقة على مساكننا الا بالقدر المسموح به اجتماعيا ، أو الجزء المخصص لهم ، وهو أمر لا تتحمل المرأة عبء اختلاله بمفردها ، فالمسكن كفهوم وكمكان تحول بصورة دراماتيكية من الوضع الجماعي الى الوضع الفردي ، وهنالك من صار ينتحي صوب اشتراطات الغالب الغربي الجمالية ، وهي قضايا جدلية متداولة ومطروقة من قبل النخب المفكرة ومستهلكة أيضا من جانب الجمهور على اعتبار أن العمارة مسألة فنية ومعاشية ، لكن النعيم استطاع أن ينضد كل تلك السياقات المتشظية في نسق أعلى الأمر الذي أكسبها بعدا ثقافيا متعاليا.
|