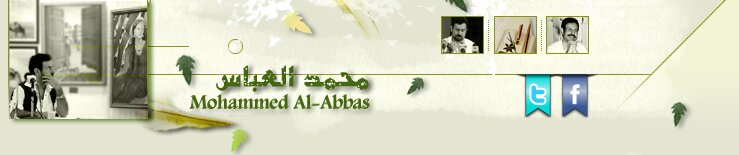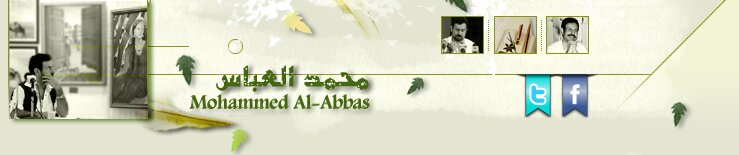طباعة طباعة  ايميل ايميل
مثاقفة النقد الثقافي
النقد الثقافي، كما أعلنه الدكتور عبدالله الغذامي، محاولة لتبصيرنا بخطر " العيوب النسقية المختبئة تحت عباءة الجمالي ". وبهذه النية التقويمية يفترض أن يكون كمشروع، إما استكمالا لما قبله من بحوث، تعديلا ولو جزئيا، أو توبة عنها، أو ربما انقلابا عليها، بحلول معرفية تقوم على كفاءة الدرس الألسني، وعليه يختصرها كمهمة بحثية في تحريك " أدوات النقد باتجاه فعل الكشف عن الأنساق وتعرية الخطابات المؤسساتية والتعرف على أساليبها في ترسيخ هيمنتها وفرض شروطها على الذائقة الحضارية للأمة". وتلك مهمة تأويلية جليلة دافعها البحث عن " حقيقة مخالفة " ومنبعها الحذر تجاه الموروث، كما يموضع امبرتو ايكو الذوات النقدية المؤولة أمام موروثاتها الثقافية، والتي قد تصبح مرتعا لسلسلة من القراءات المتشككة والمترفة تأويليا، كلما تقدس النص داخل المنظومة الثقافية واستعصى على المقاربة، وهو ما يتأكد كمقاصد عند الغذامي لحظة تسليمه بأن " الخطاب الشعري اكتسب حصانة وقداسة جعلت نقده ضربا من المحرمات الثقافية ".
وهذه الخطوة الارتدادية الى الوراء لا تنم عن حقيقة ثقافية مستقرة معرفيا، بقدر ما تتأسس على مغالطة جدلية صريحة، فقدسية الشعر عربيا لم تعصمه من النقد على مر التاريخ، فهو أكثر الخطابات عرضة للانتقاد والتصحيح، خصوصا فيما يتعلق بالمعنى الذي لم ير فيه الفارابي اتساقا مع سذاجة الايقاع مثلا ، وبدليل الشكل الأحدث للشعر، واستمرار الجدل الحاد حول قوالبه الفنية والبحث الجاد عن حواضن مادية وجودية لمضامينه، وعلى عكس ما يفترضه الغذامي لم يتواطأ النقد مع الشعر تاريخيا ولم يجاريه، برأي الدكتور عبدالله ابراهيم، وحتى مقولة أن الشعر احتكر مشروع التحديث بحاجة الى فحص.
وذلك الوهم التأويلي انما برز في سياق الكتاب نتيجة ارتهان الغذامي للنظريات الشمولية عوضا عن التحليلات الموضعية للخطابات، أو تعلقه حد الانخطاف بالنظرية والتنظير على حساب التدقيق في المفاهيم والمصطلحات، برأي الدكتور معجب الزهراني، وربما أراد الغذامي الايهام بأنه أول من وضع قداسة " ديوان العرب " تحت طائلة الشك النقدي، وأنه بهذا يخطو في أرض لم يطأها قلم للتأكيد على جسامة مهمته لتعرية الأنساق المختلة وتصحيح المكونات البنائية لذائقة الأمة، وهو أمر يمكن القيام به، حسب امبرتو ايكو، ولكن دون " إقامة حفل لتحضير الأرواح " ودون توظيف مضلل للنص.
ولكن يبدو أن الغذامي استجاب بشكل أو بآخر لنصيحة جاناتان كالر من حيث الذهاب بالتأويل الى حدوده القصوى ليثير اهتماما أكبر، فلم يكن بحاجة لمراعاة حدوده، بتصور حسين السماهيجي، إذ لم تكلف قراءته نفسها عناء البحث والانسجام لتأويليتها، وهذا ما لاحظه الدكتور معجب الزهراني أيضا بشأن نزعته التأويلية المتسمة " بنبرة عالية وبوثوقية لا تترك مجالا للحذر المعرفي " . وهكذا جاءت معالنته بموت النقد الأدبي، ثم الحرب على الشعرنة بنبرة تفضيحية رغم استدراكاته، أو اكتفائه بتعاطي مفاهيم محدودة للفاعلية الشعرية.
في كتابه يقرر بعبارة احترازية عريضة لا تخلو من الاستبراء أن في " الشعر العربي جمال وأي جمال ، ولكنه أيضا ينطوي على عيوب نسقية " إذ أن ديوان العرب من وجهته " كان هو المخزن الخطر لهذه الأنساق وهو الجرثومة المتسترة بالجماليات " الى درجة الزعم بأنه المسؤول عن التأسيس لذات تترجم وجودها في قصيدة، وتنم عن تركة ثقيلة من العيوب المقبحة والمعطلة للشخصية العربية " الشحاذ ، المنافق ، الكذاب ، الطماع " وصولا الى اتهام بصناعة الطاغية في الحياة العربية، وهو اتهام لا يبقي شيئا من دلالات الوهن والانحراف القيمي والسلوكي في المجتمع الا وحقنها في الخطاب الشعري.
وإذ يؤسس جدله ابتداء على رؤيتين متضادتين للشعر كفكرة تراثية يوتوبية، أحدهما " تعليه وتمجده وأخرى تزهد فيه وتقلل من شأنه " يندفع في الاعلاء من شأن الصيغة الثانية على حساب الأولى دون مراودة لطرد التراث من المنظومة الثقافية، انما بميل مبيت الى فكرة تأول وجودنا به، ببصيرة أبستمولوجية تحيل ذلك المفهوم من شكلانيته الساكنة الى مفهوم مادي وحركي، وكأنه يسترجع جذرية الشروط المؤسسة لذلك الفعل قبالة فعل ثقافي لاحق، وعليها يلجأ الى استفهام بصيغة جواب، فالمفزع معرفيا أن سجال الغذامي يقوم على تعزيم ديني، ليصد الأدبي بسطوته، إذ جعل " السؤال المضاد للشعر سؤالا اسلاميا من حيث المبدأ " اتكاء على الحديث الشريف " لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا " بالاضافة الى سلسلة طويلة من المقولات المتوارثة وصولا الى التأكيد على أن الشعراء يقولون ما لا يفعلون، واللافاعلية هنا ، برأيه " هي احدى عيوب الخطاب ، لأنها تسلب من اللغة قيمتها العملية، اذ تفصل بين القول والفعل " ولذلك جاء ذم الشعراء قرآنيا.
وربما نتيجة لهذا الانتحاء الطهوري اعتبره محمود زيني أول ناقد اسلامي، فيما اتهمه محمد عبدالمطلب بالرجعية النقدية. أما أسلمة السؤال المضاد للشعر فهو سؤال أدونيسي بامتياز، طالما كرره وحفر في جنباته، خصوصا في كتابه " النص القرآني وآفاق الكتابة " والذي استخدم نفس العدة من المقولات والنصوص التراثية التي تناولها الغذامي كقول الأصمعي " الشعر نكد بابه الشر ، فإذا دخل في الخير فسد " ولكن المحصلة كانت مختلفة عما آلت اليه نتائج الغذامي حيث كانت أحكامه النهائية والسلطوية لرموز الحداثة ومنجزاتها، برأي الدكتور ابراهيم غلوم " أشد ضراوة من خطاب الأصولية الدينية، واذا كان مثل ذلك يقوض نسقا فانه يبني نسقا على أنقاضه دون شك ".
ربما نجح أدونيس صاحب الخطاب " السحراني " كما يصفه الغذامي ويصمه بحداثة شكلانية ، لأنه جادل تلك المنطقة الوعرة بجرأة وبوجهة موضوعية مخالفة فيما امتصه من ألن تورين وسماه حداثيا صراع " الدنيوة والديننة " ليصل الى ادانة اللغة المؤسسية التي تغمر الذات والآخر ، والتي بدأت تباشيرها لحظة الغاء السؤال وتحويل وظيفة الشعر الى مهمة تكريسية لتمجيد الحقيقة التي جاءت بها النبوة الاسلامية، حيث الغي البعد الاستبصاري لصالح الأداة الاعلامية، حتى أن الرؤية الخليلية لم تكن سوى ترجمة دقيقة للرؤية الدينية، والشعر العربي لم يكن مطالبا للحاق بالبيان القرآني وحسب ، بل بمماهاة مضامين الوحي، كما يميل الجاحظ ، وهنا مكمن العلاقة التنابذية بين الحداثة والشعرية العربية. وكل ذلك قبل أن ينقلب أدونيس كعادته على ذلك المفهوم ويصر على أن الحداثة فعل كامن في الدين أصلا ليندس هو الآخر في خطاب أكثر جماهيرية.
المعضلة إذا ليست في المنهج أو النظرية، المستمدة برأي غلوم من تاريخانية ستيفن قرين بلاث ومن النموذج الاتصالي لخطاب جاكوبسن، لأن الكاتب يرتكز على تأسيس نظري محكم يبعث آفاقا جديدة في نقد الخطاب، ولكن تكمن المشكلة في النموذج الذي حاول من خلاله أن يهدم البناء بأكمله، أي في اتخاذه من نموذج الشاعر نسقا يكشف من خلاله الصورة الكاذبة والمزيفة في الثقافة العربية، فالشاعر خدين للماضي، وله شحنة قوية من التراث،وهو بذلك يمكن لميثولوجيا الشاعر من التحكم في تفسير معضلات ذات خطورة، ربما كان من أخطرها ان هذا النموذج يبرر للسلطة بمفهومها التراثي/الديني المتخلف مواقفها الجامدة، ويخول لها أن تجد ذرائع قوية تتحصن من خلالها لمواجهة مشروع الحداثة بأكمله.
وربما لهذا السبب تحديدا جرده ابراهيم محمود من صفة العلمية نتيجة انتقائيته وتعميمياته ولجوئه الى التفسيرات والتأويل العشوائي. وهكذا جاءت كل أسئلته البديلة، سؤال النسق بديلا عن سؤال النص، والسؤال المضمر بديلا عن سؤال الدال، وسؤال الاستهلاك الجماهيري كبديل عن سؤال النخبة، فهذه المتوالية الاستفهامية ليست سوى عناوين غير مخدومة علميا، الأمر الذي حدى بناظم عودة أيضا الى اتهامه بالانفصام والمزاجية واللاعلمية " فمرة جماليات أدونيس نخبوية ومرة مهيمنة" تماما كما وصف حسين السماهيجي قراءته لأيقونة الأنوثة بالقراءة المترصدة، اللا حيادية، من حيث اصراره على " اجراء نوع من القراءة الحنبلية للنص الأدونيسي " وهو ذات الاتهام المخفف الذي واجهه به الدكتور عبدالله ابراهيم إذ سجل عليه جملة من التناقضات حيث " تشوب تحليلاته نظرة اصلاحية تتعالى فيها أحيانا أحكام أخلاقية واعتباريه " ومن حيث اهماله " للجانب الايحائي والرمزي في الأدب والفكر والحياة لصالح الجانب التقريري الصريح والعقلاني الصرف الحامل لأنساق قيمية تربوية ".
كل تلك الملاحظات كانت مطروحة قبالة الغذامي في بواكير مشروعه حيث تمنى سعيد السريحي ملامسة " المشروطية الجمالية " وأفتقد الدكتور محمد الشوكاني مسألة " التاريخانية " لكنه استمر في تفسير موقفه من الشعرنة التي حولت الذات العربية الى " ديوان شعر " شديد الارتباط بفعل المديح والمفاخرة والمباهاة والنفاق ، وبالتالي فإن " كوننا كائنات شعرية ليس خبرا جميلا كما ظللنا نعتقد " حسب استنتاجاته، فقد تشعرنت الأنساق وصرنا فعلا " الأمة الشاعرة واللغة الشاعرة ولكن فرحنا وتباهينا بهذه الصفات ليس سوى خدعة نسقية لم نع ضررها " وعلى تلك الصدمة المعرفية/الذوقية أراد تخليصنا من خديعة ثقافية تاريخية ومن " هذه الروح المتشعرنة التي لا تسمح للذات بأن تنمو فوق ظرفها ولا تسمح لها بأن ترى بعين ناقذة لذاتها " وكأنه يريد أن يخفض من فكرة تعالي الشعر ليس على شروط الواقع والمنطق وحسب بل على شروط الزمن، وامكانية تفكيك " فعل التزمن " أو قراءته بصيغة تراجعية.
هكذا بدا الغذامي مؤولا جازما لا متشككا على عكس ما يفترضه التأويل، فقد اكتفى بتعاطى المقولات والنصوص في مستواها الاستخدامي تأويليا فعبارة " أعذب الشعر أكذبه " مقوله لا تحتمل عنده الا مدلولها النصي، وكذلك مقولة " المعنى في بطن الشاعر " دلالة على الرغبة في احتكار الحقيقة، وقول أحمد شوقي " أنتم الناس أيها الشعراء " محاولة لفرز طبقي نسقي تمييزا لفئة الشعراء وهكذا، الأمر الذي " أدى الى سقوط الشعر وبروز الشاعر " حتى يصل الى التسليم بأن " الشعر خطاب لا عقلاني واستعبادي " استنادا الى مفهوم التوحيدي في التفريق بين عقلانية النثر وحسية الشعر ، ساخرا من خرافة الشعراء الثقافية المؤسسة على التمايز الشعوري للشعراء، ومن واديهم الموهوم ( عبقر ) ومسجلا احتجاجه على التصنيف الذي أورده النقاد لطبقات الشعراء وللأسس التي انبنى بموجبها مفهوم الشاعر الفحل في مدارات التمأسس والتنمذج النسقي، والتي وصلت بشاعر مثل نزار قباني الى الإدعاء بأن الشاعر " يحمل بين رئتيه قلب الله ويضطرب على أصابعه الجحيم " كما مارست نوعا من القمع ضد شعراء الهامش ، أو تهميش من لا يدخل وفق ذلك التصنيف الى نادي الفحول.
وهذا الادعاء القائم على توظيف الخرافة الثقافية " والاعتماد عليها كقوة في الإرهاب " ليس جديدا على الذات الشعرية العربية ، حسب تحليله ، انما يأتي استكمالا للأنا الفحولية المغروسة تاريخيا وشعوريا وثقافيا في الضمير النسقي منذ زمن الجاهلية ، التي تستلهم " النحن " القبلية ، وتترجمها الى الذات المفردة ، المبالغة في ذكوريتها ، وأبويتها ، ومركزيتها المتعالية بشكل مطلق لدرجة الغاء الآخر والتعالي عليه ، والتي عززت مواقعها الطبقية من التقاء " جذرين جوهريين ومتماثلين ، أحدهما الجذر العربي المذكور ، والآخر هو الجذر الفارسي/اليوناني وهما معا يقومان على ثقافة تراتبية ذات هرم فحولي يستند على الذات المفردة المستبدة المطلقة " التي أنتجت جراء ذلك كله منظومة من الطبقيات الثقافية " كلها تقتفي أثر الهرم الطبقي الشعري ".
وهكذا يحمل الغذامي الشعر مسؤولية الانحراف بالذات العربية، والتي يؤرخ لها من نهاية العصر الجاهلي حيث حدث تطور ثقافي خطير تغير معه النسق الثقافي العربي " وتحولت " النحن " الى " الأنا " مثلما تحولت القيم من بعدها الانساني الى بعد ذاتي نفعي أناني، وتحول الخطاب الثقافي الى خطاب كاذب ومنافق " حيث تفشى ما يسميه " ثقافة المدائح " القائمة على عقد صريح وضمني بين المادح والممدوح، أحالت بموجبها مثلا " قيمة الكرم من بعدها الأخلاقي والانساني الى بعد شعري " الأمر الذي أنتج طابورا من الشعراء " تحت الطلب " يروجون لنموذجهم المدائحي ، وهذا دلالة على مدى الخراب النسقي، الذي أرادوا أن يفرضوه حتى على الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز ، حيث يصيب الغذامي التراث الشعري /النقدي بضربه قاصمة من حيث اتهامه للموروث الثقافي العربي بمنح " المنزلة لأسوأ أنواع الشعر من حيث القيمة الانسانية ".
هنا تكمن انحيازات الغذامي البحثية ، أي في مقرؤيته التاريخية والثقافية والفنية للإبداع فقد أخضع وعيه ، وحاول أن يورطنا ببساطة في وهم مضلل لمفهوم الشعر، أو هكذا تعاطاه " خطاب مجازي متعال على شروط الواقع والمنطق " ولذلك حاول الإنقلاب على ذلك الوهم، لكن علي الديري لم ير في مقترحاته جديدا، فقد توقف أمام مراوحاته لايستنتج أنه لم يتخلص من الثنائيات في رؤيته للخطاب المجازي الشعري، بقدر ما أعاد خطابه انتاجها، وهكذا أراد الثقافة العربية أن تعاضده فيما هي منقلبة عليه أصلا ومنذ زمن بعيد، متناسيا أن ذلك الاعتقاد لم يكن ملزما ولا مقنعا الا لدارسين ومتلقين لا زالوا يراوحون في المربع الأول، فقد جودل مفهوم الشعر قديما وحديثا بتنظيرات فلسفية وجمالية ونفسية وتاريخية لا تخرج به عن مدارات الحياة ، فهو يشبه الحياة ، ويشتهي أن يتطابق مع حراكها بالمفهوم النتشوي ، فالشعر في قلب الحياة وليس مجرد خطاب يحاذيها، ولكن الغذامي أراد بكل تدليلاته - النصانية - تفكيك آلية الخرافة التي ابتناها الشعراء حول ذواتهم ومكامن شعورهم ومكوناتهم الفوق-بشرية ، وفرضوا بموجبها شعرنتهم التي اندست على غفلة في أنساقنا الفكرية والسلوكية .
ولا يمكن للغذامي إيهامنا بشكل انتقائي خانق ومعطل لفاعلية الخطاب الشعري، من خلال التركيز على مظاهر لغوية ونسقية، بدعوى التفريق بين النسق والوظيفة النسقية، واستلال مقولات من سياقاتها، وقص حكايات تراثية عن عدد لا يحصى من قضايا الوجود الانساني، كما يلاحظ رورتي إزاء التأويل المضلل، الذي يتبدى اختلاله من الميل الى آلية استخدامية لا تعنى بتفكيك المقولات أو اعادة تأوينها، بقدر ما تستحوذ عليها وتعيد توظيفها دون مراعاة لشروط تولدها التاريخية والثقافية، وهو ما ينحرف بالقراءة عن قاعدة تأويلية يتخطى بها امبرتو ايكو الارث الاجتماعي الذي لا يحيل الى لغة بعينها باعتبارها نسقا من القواعد فقط، الى وساعات مفهوم يشمل، برأيه، الموسوعة العامة التي أنتجها الاستعمال الخاص لهذه اللغة، أي المواصفات الثقافية التي أنتجتها اللغة، من خلال ملاحظة العلاقة بين الوعي البشري، وحركية الواقع، التي ينبني عليها شكل الانتاج الفكري في علاقته بالشكل المادي، ضمن حاضنهما الاجتماعي.
ذلك هو ما يفتح الخطاب الشعري على احتمالات نسقية أوسع، أي من القناعة بوجودية النص الشعري، ومن الاحساس بماديته ودينامية وجوده الذي يكون النص الابداعي بمثابة الدليل على حقيقة ذلك الوجود، حيث يمكن التدليل على أنساق شعرية فنية وموضوعية مضادة لفعل المديح والتزلف والصناعة اللفظية، إذ لم يبين مثلا كيف نجا أبو نواس من تلك النسقية، ربما ليقبح الخطاب الشعري ويحمله كل أوزار وانحرافات الذات العربية وكأن الشاعر العربي يبدأ قصيدته من منطلق قيمي جمعي مهيمن وينتهي بها، رغم وجود شعر المحبين والعذريين والمتصوفين والمقهورين والمهمشين الذين يصعب على الغذامي حشرهم في قراءته النسقية التنميطية.
ويمكن التمثيل للمعذبين منهم مثلا بالشاعر يزيد بن مفرغ الحميري، الذي كان يكتب أشعاره التحريضية على حيطان الخانات عندما كان المداحون يكيلون المدائح، تماما في الفترة التي حددها الغذامي كمنطقة وعي لخراب النسق وعطالة الذات، ولما قبض عليه أرغم على محو أشعاره بأظافره حتى حفيت وسالت الدماء من أصابعه، والتاريخ يسجل سيرة سلالة من الشعراء الذين هلكوا بسبب أشعارهم ولم يتكسبوا أو يسترزقوا بالشعر، انما كانوا يحايثون واقعهم بلغة مضادة، وهكذا تنفضح آلية نسقه الثقافي، الذي سماه عمر كوش " سجن النسق " واعتبره شكلا من أشكال المصادرة لفواصل تاريخية واجتماعية وجمالية، بل ولواقع الشعراء العرب، حيث لم يميز بين مفهوم النسق بوصفه يقوم على فروض معينة وبينه كمفهوم متغير بتغير الأقاليم المعرفية والتاريخية، فالنسق الثقافي ليس سوى مفهوم فقير جدا لتحديد المركبات والحمولات والحركات اللامتناهية التي تجتازه.
وهذا الاستشهاد التدليلي مجرد مفردة صغيرة ضمن جملة طويلة تندرج في نسق جميل ومثابر من أجل الحياة، وقد رصد جذورها حسين مروة بنقد ثقافي لافت في كتابه " تراثنا كيف نفهمه " وثنى على ذلك المنزع في كتابه " دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي " ليرسم خطا بيانيا لنسق يضم فيما يضم عمرو بن أحمد الباهلي، عبدالله بن الحجاج الثعلبي، والراعي النميري، وشبيب بن يزيد بن النعمان، ودعبل الخزاعي، والكميت بن زيد الأسدي، وغيرهم ممن أرادوا بشعرهم التأكيد على وعي حقيقي بالحاجة الى الحرية، استكمالا لوعي أعمق لذلك المفهوم الانساني بدأ مع الشعراء الصعاليك، كسؤال مركزي لفئة يراهم كراتشكوفسكي انعكاسا بيئيا يتمثل الذهنية والوجدان والذات العربية بأمانة، وقد جسدوا صيغة من صيغ الاحتجاج على عالمهم الجاهلي " الذين صنفهم التمايز الاجتماعي الجديد في الجاهلية بين فئة المستثمرين - بفتح الميم الثانية -أي فقراء هذه القبيلة وتلك، بتعبير حسين مروة الذي أدرج في ذات النسق بشار بن برد وأبا نواس وغيرهما ممن يشكلون نسقا تحرريا، بالمعنى الفني والموضوعي الشامل والعميق لمفهوم الحرية، المجادل لمعاني الكرم والشهامة ودافعية الوجود الانساني، والمستكمل بنسق الشعراء المحبين الذي ينسجون ذواتهم في مدارات العاطفة والرغبة الانسانية الحرة لا التزلف والنفاق.
هذا هو جانب من الهامش الذي أرادنا الغذامي ألا نزدريه ، خروجا على نخبوية النص الجمالي الى وساعات الأفق الجماهيري وعرض القاعدة التأييدية، لنجادل ما هو أقل قيمة أدبية من النكتة والأغنية، ولنقابل به ما أعتبر - تجاوزا - أكثر أدبية ، واحتكر هذا المفهوم لزمن ، لنمارس حالة من الوعي أو النقد الانقلابي على اشتراطات المؤسسة الأدبية ( البلاغية والجمالية ) حتى ولو أمكن التهابط الى ما يتعارف عليه ثقافيا بالسوقية كما ينادى اليوم في النقديات الغربية، ثم تجاوز كل ذلك الاستهلال الى الفاقع من الأمثلة والتي لم تكن تحتاج الى أي تدليل، ولا حتى التجريب بمنهج متعال وملتبس اصطلاحيا كالنقد الثقافي، فقد لا يختلف قارئان على الإفراط البلاغي عند أبي تمام، ومبالغة المتنبي في المدائحية، ونخبوية اللغة الشعرية عند أدونيس أو تعاليها، وأنثوية المنزع الشعري عند نزار قباني، ولكن هؤلاء لا يتمثلون شعريا بمحدودية هذه الأبعاد، ولا تقوم شعريتهم على تلك العناوين وحسب، والتي سجلها الباحثون قبل الغذامي وبإدانات متعسفة ومتطرفة أحيانا جعلت شوقي عبدالأمير مثلا يزيح نزار قباني من مرتبة الشعراء الى خانة المغنيين، بالاضافة الى أن تلك المواقف ازاء شعراء بعينهم لا تؤكد بأي شكل من الأشكال تهمة تسربها نسقيا الى بقية الخطابات العربية، كما يريد التأكيد على ذلك بمجرد اعلانه - أي الغذامي - عن نقلة نوعية تمس السؤال النقدي ذاته، وتطال المصطلح والمفهوم ( النسق ) والوظيفة، والتطبيق.
ولأنه ابتدأ من نتائج معروفة ومعرّفة سلفا، وأراد أن يؤكد على أمور محسومة بدا الغذامي مرتبكا، يدور في ذات الدائرة محاولا تربيعها، لكنه لا يأتي بجديد يفتح به مفهوم الشعر، أو يطور مقولات نقدية أقدم، فهو في حقيقة الأمر لا يفضح خابيا أو مستعصيا من الأنساق الثقافية، كما يتوعد في كل منعطفات الكتاب بتطرف تأويلي، وبلغة حادة تنم عنها مفرداته وألفاظه ( خطورة – الفضيحة – رجعية – العمى الثقافي – الارهاب – تعرية - استفحال … الخ ) وكأنه يبدأ من عدم عربي بشأن هذه الحقائق، أو يقدم على هول معرفي خطير ليس أقل من نقد سلالة من القديسين أو المعصومين، كما يحاول الايهام ، متناسيا أن كل ثقافات العالم تورطت في مثقفين ومبدعين يفارق منظرهم الجمالي وكفاءتهم الفنية مفاهيمهم الحياتية كما حدث مع مايكوفسكي مثلا ، وأزرا باوند، بل والجواهري عربيا.
هكذا يبدو الغذامي في قراءته للأنساق فهو يبدو مرة وعظيا أخلاقيا، وأخرى مقرا بالشعر ومحتجا على الشعرنة. أحيانا يراهن على المقروئية ليرفع منسوب الاحساس بخطورة النسق، ولا يلبث أن ينكر أثر جماهيرية الشاعر، تماما كما يبدأ موضوعيا في مجادلته لمفهوم يريد التأكيد عليه ثم ينعطف جماليا وبشكل تعميمي غير منضبط من الوجهة المعرفية عندما يفقد القدرة على التدليل، وهي تنقلات معرفية يتطلبها " النقد الثقافي " كرؤية تقليبية للموضوعات على كافة الوجوه المحتملة، ولكنه يشترط في ذات الوقت طريقة دينامية وحفرية متعددة المرايا لا قفزات مزاجية للدفاع عن زاوية ضيقة من آفاقية الشعر، فالنقد الثقافي دراية واستحضار للتاريخ والفكر وكل أواليات المنظومة الثقافية والحواضن المادية التي أنتجت الخطاب الشعري.
وللتدليل على القديم المعاد استخدامه، لا انتاجه، بالمعنى التأويلي، يمكن العودة للمآخذ التي أخذها الغذامي على أبي تمام وجادل بموجبها جهده ومكانته الحداثية، فهو يستند في رجعية أبي تمام الى غوستاف غرونباوم في كتابه " دراسات في الأدب العربي " ويحيل ذلك الإقرار الى ملاحظة طرحها القاضي الجرجاني في وساطته، جمع فيها بين الاعجاب بأبي تمام ونقده في ذات الوقت، وسجل عليه مقولة تنفر من بعض شعره " اذا سمعت هذا فاسدد مسامعك، واستنهض ثيابك، واياك والاصغاء اليه، واحذر الالتفات نحوه، فانه مما يصدي القلب ويعميه، ويطمس البصيرة، ويكد القريحة " وهو استناد نصي لا جدلي يتصيدة الغذامي كمقولات أو مسلمات بقراءة مترصدة لا تحتاج الى نبش ولا الى تدليل، لكنه يتغاضى مثلا عن وجهة نظر الآمدي في حداثة أبي تمام.
ودون أي مفارقة أو استكمال مبتكر لما بدأه الجرجاني يستعجل الغذامي ادانة الاعتقاد والمعتقدين بحداثة أبي تمام ويعتبره دلالة فحولية لمقدرة الشاعر على التخفي تحت ستار البلاغة والمجاز والجملة البلاغية ، ومن ناحية المقروئية هي دلالة أيضا على " تمكن النسق فينا.. وعدم تطوير المقولات النقدية من مستواها الجمالي/البلاغي " التي طالما احتج على ثباتها. مكتفيا بالدلالة النصانية الصريحة ، وبالاشارة المرجعية الى كتاب سعيد السريحي مثلا " شعر أبي تمام بين النقد القديم ورؤية النقد الجديد " ومنصرفا عن التقاطع مع طروحاته، مشددا على شكلانية الحداثة عند أبي تمام، دون وقوف بحثي على ملامحها، ولا على منزعها البلاغي الذي جودل بأشكال مستفيضة في مباحث كثيرة، ليس ازاء شعرية أبي تمام وحسب بل في عمق الشعر العربي عموما كمجادلة سامي أدهم مثلا في كتابه " ما بعد الحداثة " للخطاب المختبئ وراء البيان في اللغة العربية الحاجب لوجودية النص، احتجاجا على الجمالية الفائضة التي تثقل النص وتعطل تدفقاته.
هذه هي الفضيحة التي واعدنا بها الغذامي لهدم صورة شاعر لا يحظى بمقروئية جماهيرية أصلا، ويصر على أنه أحد الشعراء الذين أسسوا لنسقية منحرفة مدسوسة على غفلة منا في سلوكياتنا واعتقاداتنا الشعورية واللا شعورية، وحداثة مزعومة الأولى بها أن تدان لا أن يقتفى أثرها. وعلى ذات الصيغة التهويلية يجادل بقية نماذجه المستهدفة فمفهوم الحداثة التي يتهم نسختها العربية بالرجعية لأنها توسلت النموذج الشعري - وهنا المفارقة من محب للشعر - يحاكم بها أدونيس من واقع كتاب قديم ( زمن الشعر ) لا يمثل رأي أدونيس المتنامي والمضطرب في كثير من الأحيان للحداثة، فأدونيس الذي تعاطى مفاهيم متعددة للحداثة كما يشرب الماء ويتنفس الهواء ليس حداثيا لأنه فحولي الخطاب والحضور والوجود، ومن التطرف والاستخفاف المنهجي القول بأن " أي قراءة لأعمال أدونيس الأخرى المبكر منها والمتأخر سيعطي النتيجة ذاتها ".
وبنفس الآلية والروح الاقصائية التي لا تكاد تلامس سطوح الأشياء ينفي المتنبي من الحداثة ويجرده من النزعة الانسانية بسبب مدائحيته واكتمال نسقيته الفحولية " فهو أقل الشعراء اهتماما بالانساني وتحقيرا له " ويجهز على نزار قباني بسبب أنثويته، التي جادلها بضيق نفسي وبوعظية أخلاقية، أو بما يشبه إدانات العقاد المباشرة لأبي نواس من واقع ومظهريات نصه، واتهامه بالتوثين الذاتي والايروسية ، فهؤلاء الشعراء انما منحوا المكانة، برأيه، لخطأ معياري عربي يمنح " المنزلة لأسوأ أنواع الشعر من حيث القيمة الانسانية ".
عند هذا المنعطف التأويلي يعلن بداية النقد الثقافي وانتهاء دور " حفاري القبور " وإن قلل من احساسه باحتياز ريادة التنظير للنقد الثقافي إثر جملة من الاعتراضات التي واجهت محاولاته الأولى عبر سلسلة من المحاضرات، وبعد أن استشعر بشيء من اليقين المعرفي، كما يبدو من كتابه، استحالة فصل النقدين الأدبي عن الثقافي، لدرجة تسليمه بأن " النقد الثقافي فرع من فروع النقد النصوصي العام " . وعلى ذلك الاستدراك المعرفي أراد أن يعيد الأمور الى نصابها المعرفي ويمارس نوعا من الجهد التأصيلي في كتابه " النقد الثقافي " لكنه عندما اقترب مما يسميه " ذاكرة المصطلح " وقف أمام مفارقة معرفية تنم عن فراغ نقدي موحش، إذ لم يجد للمصطلح أي ذاكرة عربية - تراثية أو معاصرة - عدا استدراكات طفيفة لا تكاد تذكر عند ادوارد سعيد فيما سماه بالنقد المدني، وبطبيعة الحال احالات متكررة الى كتابه " الخطيئة والتكفير " متغافلا عن جملة من التنويهات النقدية، كإشارة محمد الأسعد مثلا في كتابه " بحثا عن الحداثة " الى أهمية الاتكاء على " النقد الثقافي " كحل لكساح الأداة النقدية وقصورها المزمن عن فض النصوص الأدبية وما وراءها، أو ما وصفه محمد مفتاح لاحقا بالنقد المعرفي، وما نادت به مجلة الآداب في الخمسينيات تحت مسمى النقد العقائدي، وكذلك " النقد الشامل " الذي بشر به محمد بنيس في " حداثة السؤال " .
لكن الغذامي بدأ هذا الفصل " ذاكرة المصطلح " وكأنه تلخيصا مدرسيا لما يجري هناك، أي في دائرة الآخر الغربي، من خلال محاولاته لموضعة الفكر أو النقد في منطقة " المابين " أو " المابعد " فكل الإحالات كانت تتجه وتنهل من مصادر أجنبية، وبكثافة تدلل على جهد قرائي امتصاصي لا جدلي ولا تأصيلي، وبقراءة ليست بريئة، بتعبير التوسير، موصولة بفصل تنظيري ( النظرية والمنهج ) يجهد لتفسير نوايا البحث، وسرعان ما تتضاءل مقاصده بمجرد مجادلة مسألة النسق حيث تختفي الأدوات النقدية الغربية وتظهر المرجعيات التراثية العربية ولو بشكل مقولات واستشهادات صريحة المقاصد، والتي كانت بالفعل أكثر دينامية واقناعا مما أراده ونواه الغذامي، الى درجة أن علي الديري يرى أن النقد الثقافي، كما أراده الغذامي " لم يفتح موضوعا بقدر ما اكتشف طبقة أو موضع معروف، لم يتهيأ لأدوات النقد السابقة اكتشافه ".
ومرد الأمر كما يبدو يكمن في احساسه ورغبته بامكانية اجتراح نظرية نقدية انقلابية يكون هو مرجعها، أو ما اعتبره الدكتور معجب الزهراني " محاولة قسرية لتحرير ذلك المصطلح من ذاكرته الدلالية الغيرية بهدف استنسابه، أي تحويله إلى مصطلح ذاتي ينسب الى الباحث وبحثه " وذلك حق لا يتأتي بمجرد النيات، بل بدفع النقد ذاته من وظيفته الأدبية الى الوظيفة الثقافية، كما يبرمج المشروع استراتيجيته، أي كما حدد مهمته في تلازم جملة من الأجراءات بنقلات أشبه بالتحديات في المصطلح، والمفهوم، والوظيفة، والتطبيق، لكن الغذامي يكثر من الاستشهاد بجهود وفطنة التوحيدي والجاحظ الجرجاني وغيرهم، ويعرف كدارس أنه لا يوجد مثقف عربي لم يتحدث عن الشعر من وجهة فنية وثقافية كابن رشد وابن سينا والفارابي، ويعرف بأن النقد العربي انما قام الجانب الأهم منه على النزعة العقلانية الاعتزالية، لكنه لا يعرف أو لا يريد أن يسمي تلك الجهود ليستدمجها في منظومة مصطلح أحدث، بدليل اتكائه على " اسطورة الأدب الرفيع " لعلي الوردي الذي يشير اليه لكنه يقلل من أهميته، برأي كريم عبد ، الذي يتهمه بالسطو على أفكاره أصلا وتأسيس كتابه بخليط من ادوارد سعيد وعلي الوردي وفوكو والتوسير.
ومن جهة أخرى يتجاهل، أو ينصرف عن جهود مجايليه، إذ لا يحتوي الكتاب على احالات لمشاريع عربية حديثة تذكر سوى كتبه القديمة، ليوحي بأنه يبدأ من صفر عربي ربما، الأمر الذي حدى بشربل داغر الى اعتباره لبوسا جديدا لنقد قديم، فيما اتهمته أمينة غصن بالنرجسية والتعالي، وتأسيس نسقه من تصورات قبلية وأحكام مسبقة، أقرب الى يقين اللاهوت ومسلماته منها الى الفرضيات الجدلية التي تنفتح على الافتراض واستعادة الافتراض، مستنتجة أن النقد الثقافي هو نقد نسقي أفقي لا عمودي وفي أفقيته تكمن ضديته، وهو الأمر الذي أكده أثير محمد شهاب فقد رآه يحاول الرفع من أناه المتعالية المتضخمة ويصف نفسه بالمجتهد وهذا غير صحيح فصفة الاجتهاد تأتي من الآخرين وليس بلسان صاحب المنجز.
واذا ما تجاوزنا الروح الهجائية الوعظية المجسدة بأسلوب إنشائي، والتي تناول بها منجز أدونيس، ونزار حيث اختصر الأول كمشروع للتفحيل والثاني كمشروع للاستفحال، تتبدى معضلة الغذامي الأبرز في محاولته لقراءة الأنساق الثقافية العربية من منطلقات شعرية، حيث تكمن في رؤيته المقلوبة للآلية التي تتشكل بها القصيدة، فهو لا ينظر الى النص الشعري كمكمن للبشري في دفاعه الدائم عن وعي الوجود الانساني بقدر ما يراه إمكانا جماليا تتأسس فيه القيم والأفكار والرؤى والتصورات والمعاني، التي تصاغ بأدبية ثم يقذف بها في النسيج الثقافي والاجتماعي والسياسي، وليس العكس، أو ما تعتبره زهرة المذبوح ذهابا عكسيا " من المؤسسة الى الشعر لا من الشعر الى المؤسسة " أي أن القصيدة كلحظة تاريخية مكررة لا تمتص شيئا من حراك الواقع لتعيد صياغته على شكل منظومة من القيم والسلوكيات، بقدر ما تروج لعادات تهويمية أو نفاقية.
وهذه الهرمية المقلوبة تنافي منطقية العلاقة بين حقيقة الوعي الشعري وواقع الوجود الاجتماعي، فالعلاقة ليست أفقية الى هذا الحد من التسطيح، وعلى ذلك لا يمكن التسليم بجناية الشعر/الشعرنة على الذات العربية، إذ أن الخطاب الشعري لا يتحرك في الفراغ أو بمعزل عن بقية الخطابات، فالخطاب الشعري تفاعلي في أساسه التكوين، وبنيوي النزعة في مراداته، وعلى ذلك الأساس المقلوب وقع الغذامي في أسر النص الملفوظ دون جهد لإعادة بناء اطاره الزماني والمكاني، إكتفاء بمستوى الصوغ فيه، وهو ما يعني الانكفاء على فهم تجربة الشاعر دون وعي تجربة الوجود التي يفصح عنها النص كما تفترض الفاعلية النقدية.
واذا كان هنالك من تجاوزات وزلات للشعراء إزاء المركبات الفاعلة في بناء الذات، وهو أمر لا يمكن انكاره في كل الثقافات فانها ليست أكثر خطورة، بل لا تقارن بجنايات فقهاء البلاط مثلا، الذين ادعوا احتكار الحقيقة وحق املائها على الناس، فهنالك كانت تنبني نسقية تبريرية وتشريعية للخطأ أكثر خطورة بالمعنى البنيوي، ليس على الذات وحسب بل على منظومة القيم التي أسست لخطأ تاريخي يصعب تعديله الا بحدث تاريخي، فكل ديوان المتنبي المدائحي، بل ديوان الشعر العربي لا يعادل فتوى أو قاعدة فقهية تبريرية أو تحريضية أنتجت فرقة متطرفة أو بررت لحاكمية ديكتاتورية كالتي يتهم بها الغذامي الشاعر العربي من خلال احداث الصلة التبسيطية بين " اختراع الفحل " و " صناعة الطاغية " فالمرجئة وأخواتها المذهبية والفئوية لم تكن نتاجا للشعر ولا للشعرنة، بقدر جاءت نتيجة لفكرة امتزج فيها التاريخ والأيدلوجيا وروافد الثقافة الغنوصية والقدرية، فالقبيلة تعيد انتاج نفسها بناء على متطلبات وآليات سوسيولوجية كما يلاحظ في القاموس الاجتماعي العربي المعاصر، وليس وفق قصيدة مباهاة، أو نص تفاخري.
بهذا تشكلت الذات العربية ، وفق ما تستنتجه مدرسة التاريخ العقلاني وعلم الاجتماع الحديث ، حيث تكون مجموعة من الوقائع الاجتماعية او الدينية او الفيزيولوجية او الاخلاقية سببا لمجموعة وقائع أخرى، وليس مجرد قصيدة، فالنص الشعري دليل على الوجود المادي وليس العكس، وهذا هو ادراك التاريخ وتعميق المعرفة به، باعتقاد شبنغلر، فكما انقلب الهرم في معادلة الوعظ الديني حيث صار الجامع ( المسجد ) يملي على الناس أفكارا مجردة لتحريك الواقع الاجتماعي باتجاهات معرفة ومدروسة، بدل أن يمتص من حراك المجتمع ما يمكن أن يتحول الى عظة ملموسة وفاعلة، حدث ذات الشيء للقصيدة فقد صارت بالفعل تتأسس في مدارات تجريدية لا في حواضن مادية، ولكن ليس كل الشعر كذلك فقد كانت هنالك قصيدة تمثل صوت الناس، وتؤسس لخطاب شعري يحتج على ذلك النسق المقلوب بقوة طرد تخفف القصيدة من بيانيتها ومن مناسبيتها لتأخذها الى مكامنها الوجودية ، فالشعر كبقية الخطابات والفاعليات الانسانية بقدر ما يروج للجمال، يثابر من أجل وعي وشعور أقرب الى حقيقة تصير أغنية في قلب الحياة.
|