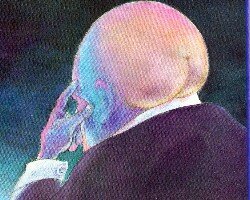
ينبغيات العقل العربي
أبناء ابن رشد
يشبه الصادق النيهوم تراجيدبا التخلف العربي بحالة " القزم " المرضية التي لا علاج لمسبباتها التكوينية، فهي على درجة خطيرة من التجذر، إذ تحيل إلى جملة من الإختلالات الثقافية المتأصلة، والمتناغمة بنيويا مع طقوسية " جلد الذات " كما صار يمارسها طابور طويل من " نقاد العقل العربي " الذين أدمنوا بحس ( سادي- مازوخي ) تقليب وجوه الأزمة السياسية والإجتماعية والإقتصادية والنفسية بحثا عن أكثر الأسباب جناية على ذلك العقل الذي دخل مرحلة السبات أو ربما الإنطفاء منذ زمن بعيد، والإدعاء الضمني أو الصريح بوراثة نزعة ابن رشد العقلية، والإندساس في نادي العقلانيين.
ولأنه - أي العقل العربي - يمثل ما هو أكثر من الخارطة المعرفية لحضارة سادت ثم بادت، أغرى العقل العربي حتى المثقف الآتي من دوائر " الآخر " بمناقدته، والتنقيب الحفري حتى في أنسجته النفسية والروحية، كما ساجله مثلا الأنثربولوجي الثقافي رافائيل باتاي بكتابه الهام " العقل العربي " والذي صار دليلا غربيا لإختراق الذهنية العربية، ومقررا تربويا للمقاتلين الذين يتم اعدادهم لاحتلال الأرض العربية، والتنكيل النفسي والجسدي بالإنسان العربي.
هكذا صار العقل العربي عرضة للمساءلة ولكن بمنطق تحقيري، فهو موصوم بالاختراق، والتشوه، والفحولة، والتهجير، والخيانة، والآبائية، والفئوية، والطائفية، واللاعقلانية، والإنشراخ، والإرجائية، والعرفانية، والوقوع تحت سطوة الخرافة، والقابلية للإحتلال، فهذا العقل " المستقيل " كما وصفه محمد عابد الجابري، أو " المقال " كما رد عليه طيب تيزيني، يبدو " مستسلما " عند خالد يونس خالد، وفيه بعض " الهرمسية " بالنسبة لعلي تركي الربيعو، وربما بسبب كل تلك الرزايا المحقونة في خلاياه ألبسه العفيف الأخضر تاج " الحماقة " فنقاده لم يختبروه على اشتراطات الكوني، بقدر ما أرادوا توريطه في الجزئي وانحرفوا به عن متطلبات المعرفي إلى هباءات القومي، حتى صار مرتعا للحراثة، بتصور شكري الهزّال، فهو حقل مشاع لوابل من المصطلحات الاعلامية المبرمجة والموجهة من دوائر الآخر، بكل ما تحمله تلك البرمجة من حس تآمري.
وبموجب تلك الإتهامات التبخيسية أخضع العقل العربي إلى وصفات تنهيض حضاري أشبه بالينبغيات المنتجة من ذهنيات أفقية تعيد تدوير الأسئلة وتعيد صياغتها على مستوى الكلام في حلقوية بائسة، فقد بدأ الجابري أول المعالجات العصرية بإخراجه من " البرهانية " وأفرغه من شروطه التاريخية، مؤكدا على الحاجة إلى قطيعة ابستمولوجية مع المسببات والإعلان بما يشبه صافرة البدء عن " ينبغية نقد العقل العربي" من خلال تأمل وتفكيك البنية التي يدّثر فيها عوراته، أو ما اعتبره محمد جابر الأنصاري في " مساءلة الهزيمة " ينبغية العودة إلى العمق التاريخي لرصد سيرة العقل العربي، وتفضبح الخفي والمعلن من عيوبه، حتى يمكن الوصول به إلى متطلبات العصر، أي اختباره على ضرورات اللحظة، كما يميل شحاذه الخوري الذي يرى ينبغية أن تطاله الحداثة.
وكعادته أو رغبته المزمنة في الإلتفات إلى الوراء بدعوى التأصيل صار أدونيس يبحث عن سر تقهقر ذلك العقل العاطل ليؤكد على " ينبغية البحث في أركيولوجيا الغياب ". كما حاول سمير أمين بمثاليته العلمية أن يفرض " ينبغية فك الارتباط " عن المركز، ويعني به الغرب . ورأى برهان غليون أن الحل قد يأتي به بصيص من الديمقراطية، والتأسيس لبعض مقومات المجتمع المدني، بعد التأكيد أولا على " ينبغية البحث عن مسببات اغتيال العقل العربي ". أما أحمد القديدي فقال بينبغية البدء بانتفاضة تنتشل العقل العربي من هجعته، فيما تساءل نبيل علي عن ينبغية الرد من جانب العقل العربي على إعصار المعلومات في " زمن النت " ليتمكن من توليد معارفه الجديدة، ويتأهل للحاق بآفاق الحداثة، أو التدرب على عاداتها على الأقل.
ومن نفس المنطلقات التنهيضية رفع محمد أحمد النابلسي من منسوب الخطر الذي يتهدد عقل الأمة، وارتأى ضرورة التدخل ( النفسي ) بين العقل العربي وطوفان الكوارث التي يتعرض لها على كافة المستويات للحؤول دون انشطاره، وهو ما يتناسب مع ينبغية التدخل ( الفكري ) كما أطلقها عبدالله النفيسي لمنع احتلال العقل العربي بعد احتلال أرضه ونهب ثرواته، وهي ذات الدعوة التي أطلقها صلاح سالم كينبغية لإيقاظ العقل ( السياسي ) العربي، وإنقاذ مستقبل النظام السياسي العربي، فيما رأى شريف الشوباشي في بحثه المثير للجدل " لتحيا اللغة العربية .. يسقط سيبوية " ينبغية تحرير العقل العربي من منظور ( لغوي ) بعد أن أصبحت اللغة العربية إسارا يخنق العقل العربي ويسبب التخلف والجمود والتراجع الحضاري.
ومن موقعه أكد محمد حسن الأمين على " ينبغية تحرير العقل العربي من سطوة المقدس " وتخليصه من الخرافة، وكأنه يؤيد صادق جلال العظم في ينبغية " نقد الفكر الديني " قبل أي شيء للخلاص من " ذهنية التحريم ". كما أصر علي القاسمي على ينبغية " بلورة تصور ثقافي عربي لمفاهيم العقل العربي " واستقراء الأوليات العميقة، التي تتحكم في تكوينه والتي تمنحه خصوصيته الأنطولوجية، رغم أن خيري منصور يصر على عاداته في التهكم المر، فيستصعب أن يطال هذا العقل المنهك مرتقيات ما بعد الحداثة، لأنه يعيش لقطة ارتكاسية تجعله جديرا وبامتياز بلحظة " ما قبل الحراثة ".
ومقابل كل ذلك التحشد التأليفي للعقل العربي، هنالك من لا يقر ذلك الوجود الموحد، كهشام غصيب مثلا الذي يراه مخالفا لجملة من الاشتراطات المعرفية والجمالية، وهو الأمر المؤكد عليه عند محمود أمين العالم الذي يرى أيضا أن من الواجب إبداله إلى تعبير فكر عربي بحيث يتحول العقل إلى " فكر وممارسة " لكن ناصر الحجاج يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك ويعلن ينبغية أكثر حدة، فبتصوره أن الأوان قد آن للكف عن استخدام مصطلحات العقل أو الفكر العربي أو كل ما يحيل إلى خرافة الوحدانية الفكرية أو القومية إنطلاقا من تشظي العقل العربي في الأساس، وعدم ائتلافه أصلا ضمن منظومة معرفية أو حتى في بطانة وجدانية.
ويبدو أن كل تلك " الينبغيات " وغيرها مما لا يحصى من الإجتهادات لم تحدث تماسها إلا مع زبد الأسئلة المزمنة للعقل العربي المزمنة رغم المحاولات الجادة بين آونة وأخرى لإنعاشه بحداثة العلوم الإنسانية، فلا عصروية طه حسين أنقذته من أسر " الماضوية " ولا انقطاعية سيد قطب منعت عنه طوفان " الغربنة " ولا " تعادلية " زكي نجيب محمود أصابته بشيء من الوضعية أو العلمانية، فالمجتمع العربي يتعسكر ولا يتمدين، والتوريث البيولوجي للحاكمية يهزم كل شعارات الصراخ الأيدلوجي وهكذا، ليبقى التخلف صناعة عربية بامتياز، ربما لأن تشخيص الداء لم يصل الى سر العطب الذي أصاب جوهر ذلك العقل منذ آخر نكبة للمعتزلة ربما، والإجهاز المبرمج من مختلف الطوائف والمذاهب على كل ما يمت إلى النزعة العقلية بصلة.
وربما لهذا السبب المسكوت عن تداعياته، رأى بعض نقاد العقل العربي الحل في توأمته بالعقل الإسلامي، او استدماجه في ذلك المهاد الثيولوجي لإضفاء بعض الروحانية عليه أو التخفيف من خيباته بميتافيزيقيا الإيمان الغيبي، وهو اشتغال لم يسلم منه مفكر عربي حديث، كما تمثل ذلك مثلا في ينبغية المماثلة التي أرساها جورج طرابيشي في " وحدة العقل العربي الإسلامي " فيما بدى حينها استجابة لمناخ بمواصفات توفيقية، وما تولد عن ذلك من دعوة إلى تأمل وحدة النظام المعرفي، بقراءة اتصالية، لا انقطاعية لتجسير ما خرّبه السياسي، وهو ما يتوازى مع ما حاوله فهمي جدعان بقراءته لأسس التقدم عند مفكري الإسلام، وباقي السلالة من نقاد العقل ( العربي/الإسلامي ).
لقد أرادت كل تلك الينبغيات الإجابة على مكمن الخلل بحثا عن عناصر قوته وتفعيله، أي نفي مزاعم العطب التكويني عنه، واحتمال تلفه جراء تعرضه لغزوات خارجية متلاحقة من المغول والصليبيين والإستعمار بشقيه القديم والحديث، وعليه انشغل نقاد العقل العربي في البحث أيضا فيما يمثله الماضي من تعويق قياسا إلى معضلات الراهن، الأمر الذي أصابه بانفصام نتيجة اختباره على حافة ديالكتيك اشكالي لم تنحسم فيه مؤثرية الماضي في الحاضر ولا العكس، فأغلب تلك المراودات لم تكن سوى مشاريع فردية تتصارع فيما بينها ولا تتكامل، بل تقوم كل تلك الذوات العارفة بتضئيل جهود بعضها البعض إنطلاقا من تموضعات طبقية، أو تمركزات ايدلوجية أو حتى تحاقد شخصي أو عناد مزاجي أحيانا يعيد إلى الأذهان مرحلة " تهافت الفلاسفة ".
محمد أركون بكل فتوحاته وارثه الأناسي، مجرد كذبة معرفية كبيرة، حسب منذر العياشي. وحسين مروة صاحب موسوعة " الحركات الفكرية في الإسلام " من وجهة نظر رضوان السيد باحث محافظ وقليل الموهبة، وكذلك الجابري، برأيه، مجرد صائغ لنتائج كتاب " المحنة " لفهمي جدعان بطريقة تبسيطية وشعبوانية، أو مبدل لمصطلح " الدلالة السياسية " بمصطلح " المعقولية السياسية ". وأدونيس بثابته ومتحوله، حسب صادق جلال العظم صاحب خطاب رجعي، وهذا هو حال أغلب خطابات المفكرين العرب، ونقاد العقل العربي، برأي رشدي فكار، فهم ضحايا منظومة الفكر الوضعي، وهو ما يتوافق تماما مع رأي نذير العظمة ازاء ميشيل عفلق وباقي السلالة.
إذا، ليس من المستغرب ولا المستهجن أن يراهم الطيب تيزيني من نفس المنظور التصنيفي في معيارية التراث والثورة، فقد رتّبهم وفق آلية فرز باترة إلى ماضويين وتلفيقويين وتوفيقويين ومركزويين وهكذا، وكأنه يكرّس تلك الذهنية الإقصائية التي حشر بها جورج طرابيشي طابورا طويلا من النخب الناقدة للعقل العربي في سلة واحدة كمحمد عابد الجابري، وحسن حنفي، ومحمد عمارة، وزكي الأرسوزي، واعتبرهم مجرد قصابين في ملحمة التراث، لتكون تلك السجالية المحدّثة لبوسا جديدا لينبغية أكثر قدامة هي " نقد .. نقد العقل العربي " . إنها لحظة " تهافت المناقدة ".
ايلاف - الأربعاء 1 ديسمبر 2004
الصورة للفنان علي فرزات